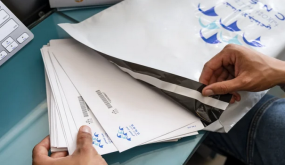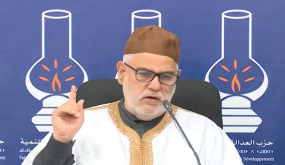الجامعة المغربية بين حمى الدرس الافتتاحي و المشهد الأكاديمي ..

تازة بريس
تشهد الجامعة المغربية في الآونة الأخيرة “حُمّى” الدرس الافتتاحي، خصوصًا على مستوى مسالك “الماستر”، حيث طغى الجانب البراغماتي والنفعي على المشهد الأكاديمي. فالدرس الافتتاحي لم يعد “اعترافًا بالمعرفة” بقدر ما أصبح “عملية علاقات عامة” متكاملة الأركان؛ لقد خرج من فضاء الإبستمولوجيا ليدخل فضاء “التسويق (الماركتينغ) الأكاديمي”. أضحى “الماستر” اليوم يتعامل مع نفسه كشركة منافسة في السوق، وباتت استضافة شخصية عمومية لإلقاء درس افتتاحي بمثابة “إطلاق منتج جديد”. فالهدف لم يعد نشر العلم فحسب، بل إقناع الطلبة ــ الزبائن ــ بأن هذا المسلك هو “موطن العبقرية”، من خلال التركيز على الحضور النخبوي والتغطية الإعلامية، في رسالة ضمنية مفادها: “نحن هنا، ونحن الأفضل”.
لم يعد الدرس الافتتاحي يُقيَّم بمحتواه العلمي المنشور في المجلات المحكمة، بل بمدى “الضجيج” الذي يتركه. يتم استثمار الوسائط الرقمية لتحويل المحاضرة إلى “تريند” مؤقت، حيث أصبح هذا الضجيج هو العملة الجديدة التي تقيس بها “الماسترات” نجاحها، تمامًا كما تقيس شركات السينما نجاح أفلامها في شباك التذاكر. وهكذا، صار الدرس الافتتاحي عرضًا استثماريًا غير مباشر، رسالته الضمنية: “استثمروا في ماسترنا، فنحن نمتلك الرؤية التي ستشكل المستقبل”. في هذا السياق، يصبح الأستاذ “رجل مبيعات” شديد الأناقة، ما دام “التغليف” هو الأهم. وبعدما كان الدرس الافتتاحي يهدف إلى إثارة القلق الفكري، أضحى يثير الرغبة في “الشراء”. إن الغاية هي إبهار الطالب وجعله يشعر بأن انضمامه لهذا “الماستر” دون غيره هو “تذكرة دخول” إلى نادي المحظوظين، تمامًا كما تختار الماركات العالمية وجوهًا شهيرة للترويج لمنتجاتها. فالطالب ــ الزبون الملول ــ قد يغادر “المحل” (الماستر) بحثًا عن بديل أكثر إثارة. وهكذا، لم يعد الدرس نصًا يُقرأ، بل مجرد خلفية لصورة “سيلفي” ينشرها الطلبة على حساباتهم، حيث يتحول الدرس الافتتاحي إلى “خدمة ما بعد البيع” تهدف إلى تأكيد صواب قرار الانضمام لدى الطالب وذويه.
لقد تحوّل الدرس الافتتاحي من لحظة تأسيس علمي إلى موسم تخفيضات فكري. والمأساة تكمن في أن الطالب الذي يأتي كزبون يبحث عن السهولة والوجاهة، ينتهي به الأمر بالحصول على “قشور المعرفة” مغلفة بورق هدايا فاخر. كان الدرس الافتتاحي لحظة يمارس فيها المفكر قطيعته الإبستمولوجية، كما فعل فوكو في “نظام الخطاب” وبورديو في “درس في الدرس”. أما اليوم، فقد تحولت العديد من الدروس الافتتاحية إلى طقس احتفالي يهدف إلى تلميع صورة المؤسسة، حيث أضحى التركيز على الحضور والشكليات مقدمًا على اجتراح “براديغم” جديد أو أطروحة ثورية. أضحى “الظهور” أهم من “الجوهر”؛ فالدرس الافتتاحي غالبًا ما يُصمَّم ليكون مادة ترويجية قابلة للاستهلاك السريع على وسائل التواصل الاجتماعي: مقاطع قصيرة، وعناوين جذابة مسطحة. هذا الضغط الإعلامي جعل الأكاديميين يتجنبون التعقيد الضروري والجرأة النقدية التي ميزت دروس بورديو أو دريدا. يأتي الدرس الافتتاحي في الفضاء الجامعي المغربي في سياق تحوّل الجامعة من فضاء للبحث عن الحقيقة إلى “مقاولة تعليمية”. أصبح الدرس أشبه بعرض تسويقي يتجنب فيه المحاضر نقد المؤسسة والممارسة، مما أفقده ثقله التحرري. وهذا التسويق الفج هو أحد أسباب تراجع قيمة الشهادات الجامعية في سوق العمل الحقيقي، حيث يصطدم الطالب ــ الزبون ــ بواقع يختلف تمامًا عن “عرض الألعاب النارية” الذي شاهده في الافتتاح.
لقد كان فوكو وبورديو يتحدثان من موقع “المثقف الكلي” الذي يربط القانون بالتاريخ وبالفلسفة وبالسياسة. أما اليوم، ومع هيمنة التخصص الدقيق، أصبحت الدروس الافتتاحية تقنية مغرقة في التفاصيل، بحيث لم تعد تخاطب “الإنسان” أو “المجتمع”، بل حفنة من المختصين، مما أفقدها طابعها كبيان إنساني عام. قد يُجادل البعض بأن الدروس الافتتاحية أصبحت أكثر انفتاحًا وأقل نخبوية، وهذا صحيح تقنيًا، لكن هذا الانفتاح جاء على حساب الراديكالية الفكرية. فبدلًا من أن يرفع الدرس مستوى الجمهور إلى تعقيد الفكر، تم إنزال الفكر ليتناسب مع سهولة التلقي. يعاني الدرس الافتتاحي اليوم من فقدان الهيبة الفكرية لصالح الهيبة الإجرائية أو التسويقية؛ إذ لم نعد ننتظر من المحاضر أن يغير طريقة رؤيتنا للعالم، بل أن يفتتح السنة الدراسية بسلام. لقد تحول من “نظام خطاب” يفكك السلطة، إلى “خطاب منظم” يخدم السلطة الأكاديمية.
كانت أهمية الدروس الافتتاحية (Leçons inaugurales) تكمن في التقاليد الأكاديمية الفرنسية، وتحديدًا في “كوليج دو فرانس”، في كونها ليست مجرد محاضرة أولى، بل بيانًا فكريًا يحدد فيه المحاضر قطيعته مع الماضي ويرسم خريطة طريقه المستقبلية. أما اليوم، فقد تحولت إلى أداة لـ “إعادة الإنتاج”، حيث لا تستمع المؤسسة لما يُقال بقدر ما تحتفل بالحدث ذاته. في هذا السياق، يمارس الأستاذ “عنفًا رمزيًا” تحت غطاء العلم، إذ يفرض لغته ومصطلحاته ورؤيته للعالم على الحضور الذين يصمتون إجلالًا لـ “الحقيقة”. والمأساة أن هذا الصمت يعيد إنتاج علاقة الهيمنة بين من يملك المعرفة ومن يتلقاها، وهو ما حذّر منه بورديو وفوكو. وحتى عندما يحاول المحاضر أن يكون مبدعًا، يجد نفسه سجينًا لـ “الهابيتوس” (Habitus) الأكاديمي، حيث الضغط للامتثال لتقاليد اللغة الرصينة والاستشهادات المعقدة يعيد إنتاج التميز الطبقي للثقافة العالية.
إن الدرس الافتتاحي لم يعد فعل قطيعة، بل فعل استمرارية. فالجامعة المغربية لديها قدرة هائلة على “هضم” منتقديها؛ فكلما كان المفكر ناقدًا لها، زاد تهميشه (أو احتواؤه)، لتثبت بذلك عدم قدرتها على استيعاب التنوع. المأساة هي أن الدرس الذي وُضع لتحرير الفكر أصبح اليوم “الختم الرسمي” الذي يُزكّي المؤسسة، حيث تحوّل المفكر من “مطرقة تكسر الأصنام” إلى “بخور” يطيّب الفضاء الأكاديمي.
مقال رأي للأستاذ محمد مونشيح عن جريدة “لكم”